وفيها دخلت الديلم الدينور فسبوا وقتلوا
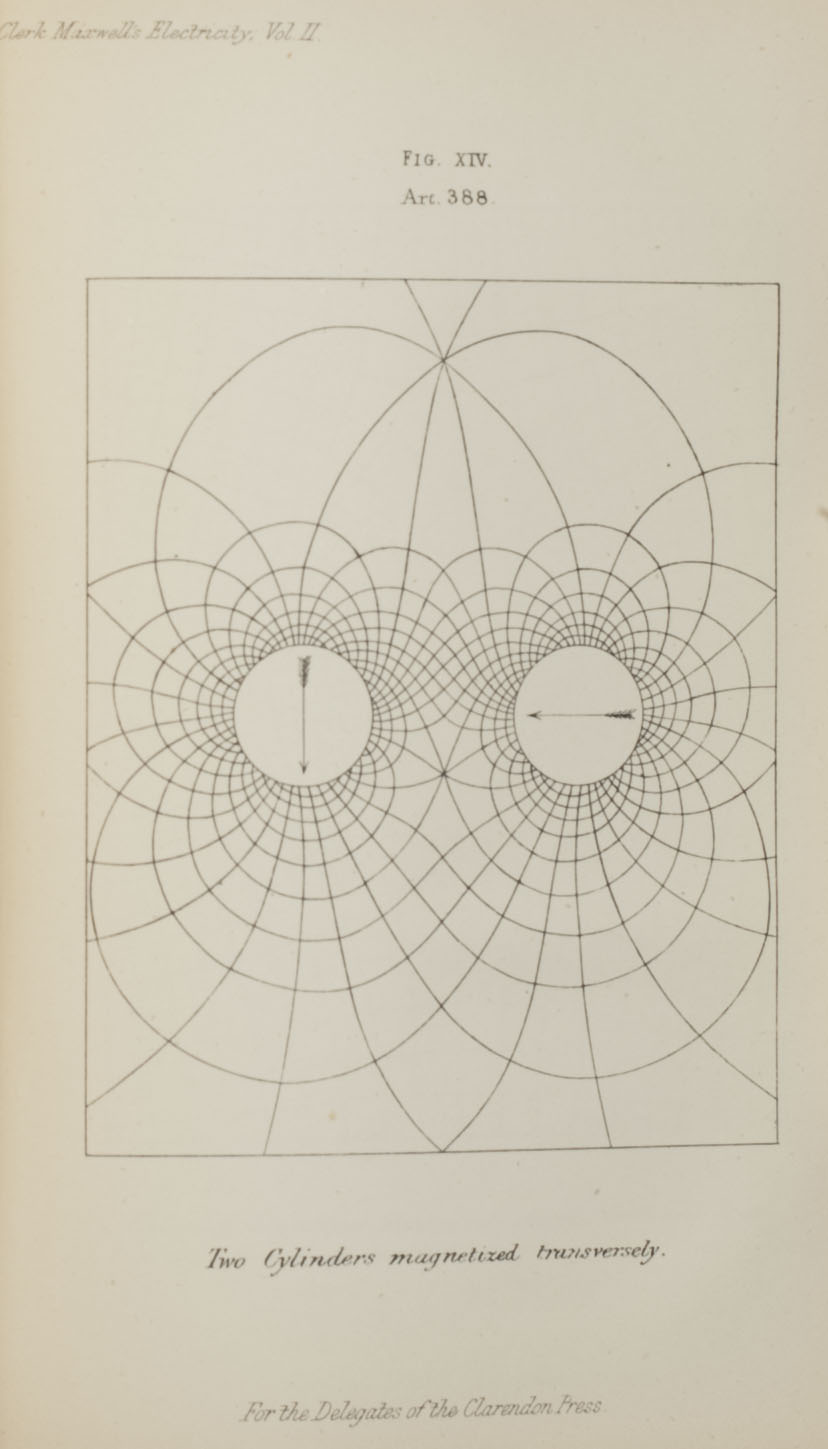 بعث ابن عمر ومحمّد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأمثالهم فلم ينكروا على الأمراء شيئا ولا رأوا عليهم طعنا وأدّوا ذلك كما علموه فلم ينقطع الطّعن من أهل الأمصار وما زالت الشّناعات تنمو ورمي الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمر وشهد عليه جماعة منهم وحدّه عثمان وعزله ثمّ جاء إلى المدينة من أهل الأمصار يسألون عزل العمّال وشكوا إلى عائشة وعليّ والزبير وطلحة وعزل لهم عثمان بعض العمّال فلم تنقطع بذلك ألسنتهم بل وفد سعيد بن العاصي وهو على الكوفة فلمّا رجع اعترضوه بالطّريق وردّوه معزولا ثمّ انتقل الخلاف بين عثمان ومن معه من الصّحابة بالمدينة ونقموا عليه امتناعه من العزل فأبى إلّا أن يكون على جرحة 97 ثمّ نقلوا النّكير إلى غير ذلك من أفعاله وهو متمسّك بالاجتهاد وهم أيضا كذلك ثمّ تجمّع قوم من الغوغاء وجاءوا إلى المدينة يظهرون طلب النّصفة من عثمان وهم يضمرون خلاف ذلك من قتله وفيهم من البصرة والكوفة ومصر وقام معهم في ذلك عليّ وعائشة والزّبير وطلحة وغيرهم يحاولون تسكين الأمور ورجوع عثمان إلى رأيهم وعزل لهم عامل مصر فانصرفوا قليلا ثمّ رجعوا وقد لبّسوا بكتاب مدلّس يزعمون أنّهم لقوة في يد حامله إلى عامل مصر بأن يقتلهم وحلف عثمان على ذلك فقالوا مكّنّا من مروان فإنّه كاتبك فحلف مروان فقال ليس في الحكم أكثر من هذا فحاصروه بداره ثمّ بيّتوه على حين غفلة من النّاس وقتلوه وانفتح سعر باب المنيوم للحمام الفتنة فلكلّ من هؤلاء عذر فيما وقع وكلّهم كانوا مهتمّين بأمر الدّين ولا يضيعون شيئا من تعلّقاته.
بعث ابن عمر ومحمّد بن مسلمة وأسامة بن زيد وأمثالهم فلم ينكروا على الأمراء شيئا ولا رأوا عليهم طعنا وأدّوا ذلك كما علموه فلم ينقطع الطّعن من أهل الأمصار وما زالت الشّناعات تنمو ورمي الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمر وشهد عليه جماعة منهم وحدّه عثمان وعزله ثمّ جاء إلى المدينة من أهل الأمصار يسألون عزل العمّال وشكوا إلى عائشة وعليّ والزبير وطلحة وعزل لهم عثمان بعض العمّال فلم تنقطع بذلك ألسنتهم بل وفد سعيد بن العاصي وهو على الكوفة فلمّا رجع اعترضوه بالطّريق وردّوه معزولا ثمّ انتقل الخلاف بين عثمان ومن معه من الصّحابة بالمدينة ونقموا عليه امتناعه من العزل فأبى إلّا أن يكون على جرحة 97 ثمّ نقلوا النّكير إلى غير ذلك من أفعاله وهو متمسّك بالاجتهاد وهم أيضا كذلك ثمّ تجمّع قوم من الغوغاء وجاءوا إلى المدينة يظهرون طلب النّصفة من عثمان وهم يضمرون خلاف ذلك من قتله وفيهم من البصرة والكوفة ومصر وقام معهم في ذلك عليّ وعائشة والزّبير وطلحة وغيرهم يحاولون تسكين الأمور ورجوع عثمان إلى رأيهم وعزل لهم عامل مصر فانصرفوا قليلا ثمّ رجعوا وقد لبّسوا بكتاب مدلّس يزعمون أنّهم لقوة في يد حامله إلى عامل مصر بأن يقتلهم وحلف عثمان على ذلك فقالوا مكّنّا من مروان فإنّه كاتبك فحلف مروان فقال ليس في الحكم أكثر من هذا فحاصروه بداره ثمّ بيّتوه على حين غفلة من النّاس وقتلوه وانفتح سعر باب المنيوم للحمام الفتنة فلكلّ من هؤلاء عذر فيما وقع وكلّهم كانوا مهتمّين بأمر الدّين ولا يضيعون شيئا من تعلّقاته.
وما زال الأمر في الدّول قبل الإسلام هكذا حتّى جاء الإسلام وصار الأمر خلافة فذهبت تلك الخطط كلّها بذهاب رسم الملك إلى ما هو طبيعيّ من المعاونة بالرّأي والمفاوضة فيه فلم يمكن زواله إذ هو أمر لا بدّ منه فكان صلّى الله عليه وسلّم يشاور أصحابه ويفاوضهم في مهمّاته العامّة والخاصّة ويخصّ مع ذلك أبا بكر بخصوصيّات أخرى حتّى كان العرب الّذين عرفوا الدّول وأحوالها في كسرى وقيصر والنّجاشيّ يسمّون أبا بكر وزيره ولم يكن لفظ الوزير يعرف بين المسلمين لذهاب رتبة الملك بسذاجة الإسلام وكذا عمر مع أبي بكر وعليّ وعثمان مع عمر وأمّا حال الجباية والإنفاق والحسبان فلم يكن عندهم برتبة لأنّ القوم كانوا عربا أميّين لا يحسنون الكتاب 132 والحساب فكانوا يستعملون في الحساب أهل الكتاب 133 أو أفرادا من موالي العجم ممّن يجيده وكان قليلا فيهم وأمّا أشرافهم فلم يكونوا يجيدونه لأنّ الأميّة كانت صفتهم الّتي امتازوا بها وكذا حال المخاطبات وتنفيذ الأمور لم تكن عندهم رتبة خاصّة للأمّيّة الّتي كانت فيهم والأمانة العامّة في كتمان القول وتأديته ولم تخرج السّياسة إلى اختياره لأنّ الخلافة إنّما هي دين ليست من السّياسة الملكيّة في شيء وأيضا فلم تكن الكتابة صناعة فيستجاد لخليفة أحسنها لأنّ الكلّ كانوا يعبّرون عن مقاصدهم بأبلغ العبارات ولم يبق إلّا الخطّ فكان الخليفة يستنيب في كتابته متى عنّ له من يحسنه وأمّا مدافعة ذوي الحاجات عن أبوابهم فكان محظورا بالشّريعة فلم يفعلوه فلمّا انقلبت الخلافة إلى الملك وجاءت رسوم السّلطان وألقابه كان أوّل شيء بدئ به في الدّولة شأن الباب وسدّه دون الجهور بما كانوا يخشون عن أنفسهم من اغتيال الخوارج وغيرهم كما وقع بعمر وعليّ ومعاوية وعمر بن العاصي وغيرهم مع ما في فتحه من ازدحام النّاس عليهم وشغلهم بهم عن المهمّات فاتّخذوا من يقوم لهم بذلك وسمّوه الحاجب وقد جاء أنّ عبد الملك لمّا ولّى حاجبه قال له «قد ولّيتك حجابة بابي إلّا عن ثلاثة المؤذّن للصّلاة فإنّه داعي الله وصاحب البريد فأمر ما جاء به وصاحب الطّعام لئلّا يفسد» ثمّ استفحل الملك بعد ذلك فظهر المشاور والمعين في أمور القبائل والعصائب واستئلافهم وأطلق عليه اسم الوزير وبقي أمر الحسبان في الموالي والذّمّيّين واتّخذ للسّجلّات كاتب مخصوص حوطة على أسرار السّلطان أن تشتهر فتفسد سياسته مع قومه ولم يكن بمثابة الوزير لأنّه إنّما احتيج له من حيث الخطّ والكتاب لا من حيث اللّسان الّذي هو الكلام إذ اللّسان لذلك العهد على حاله لم يفسد فكانت الوزارة لذلك أرفع رتبهم يومئذ في سائر دولة بني أميّة فكان النّظر للوزير عامّا في أحوال التّدبير والمفاوضات وسائر أمور الحمايات والمطالبات وما يتبعها من النّظر في ديوان الجند وفرض العطاء بالأهليّة وغير ذلك فلمّا جاءت دولة بني العبّاس واستفحل الملك وعظمت مراتبه وارتفعت وعظم شأن الوزير وصارت إليه النّيابة في إنفاذ الحلّ والعقدتعيّنت مرتبته في الدّولة وعنت لها الوجوه وخضعت لها الرّقاب وجعل لها النّظر في ديوان الحسبان لما تحتاج إليه خطّته من قسم الأعطيات في الجند فاحتاج إلى النّظر في جمعه وتفريقه وأضيف إليه النّظر فيه ثمّ جعل له النّظر في القلم والتّرسيل لصون أسرار السّلطان ولحفظ البلاغة لما كان اللّسان قد فسد عند الجمهور وجعل الخاتم لسجلّات السّلطان ليحفظها من الذّياع والشّياع 134 ودفع إليه فصار اسم الوزير جامعا لخطّتي السّيف والقلم وسائر معاني الوزارة والمعاونة حتّى لقد دعي جعفر بن يحيى بالسّلطان أيّام الرّشيد إشارة إلى عموم نظره وقيامه بالدّولة ولم يخرج عنه من الرّتب السّلطانيّة كلّها إلّا الحجابة الّتي هي القيام على الباب فلم تكن له لاستنكافه عن مثل ذلك ثمّ جاء في الدّولة العبّاسيّة شأن الاستبداد على السّلطان 135 وتعاور فيها استبداد الوزارة مرّة والسّلطان أخرى وصار الوزير إذا استبدّ محتاجا إلى استنابة الخليفة إيّاه لذلك لتصحّ الأحكام الشّرعيّة وتجيء على حالها كما تقدّمت فانقسمت الوزارة حينئذ إلى وزارة تنفيذ وهي حال ما يكون السّلطان قائما على نفسه وإلى وزارة تفويض وهي حال ما يكون الوزير مستبدّا عليه ثمّ استمرّ الاستبداد وصار الأمر لملوك العجم وتعطّل رسم الخلافة ولم يكن لأولئك المتغلّبين أن ينتحلوا ألقاب الخلافة واستنكفوا من مشاركة الوزراء في اللّقب لأنّهم خول لهم فتسمّوا بالإمارة والسّلطان وكان المستبدّ على الدّولة يسمّى أمير الأمراء أو بالسّلطان إلى ما يحلّيه به الخليفة من ألقابه كما تراه في ألقابهم وتركوا اسم الوزارة إلى من يتولّاها للخليفة في خاصّته ولم يزل هذا الشّأن عندهم إلى آخر دولتهم وفسد اللّسان خلال ذلك كلّه وصارت صناعة ينتحلها بعض النّاس فامتهنت وترفّع الوزراء عنها لذلك ولأنّهم عجم وليست تلك البلاغة هي المقصودة من لسانهم فتخيّر لها من سائر الطّبقات واختصّت به وصارت خادمة للوزير واختصّ اسم الأمير بصاحب الحروب والجند وما يرجع إليها ويده مع ذلك عالية على أهل الرّتب وأمره نافذ في الكلّ إمّا نيابة أو استبدادا واستمرّ الأمر على هذا ثمّ جاءت دولة التّرك آخرا بمصر فرأوا أنّ الوزارة قد ابتذلت بترفّع أولئك عنها ودفعها لمن يقوم بها للخليفة المحجور ونظره مع ذلك متعقّب بنظر الأمير فصارت مرءوسة ناقصة فاستنكف أهل هذه الرّتبة العالية في الدّولة عن اسم الوزارة وصار صاحب الأحكام والنّظر في الجند يسمّى عندهم بالنّائب لهذا العهد وبقي اسم الحاجب في مدلوله واختصّ اسم الوزير عندهم بالنّظر في الجباية.
والإجماع حجّة كما عرف ولا يتّهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنّه مأمون على النّظر لهم في حياته فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماتهخلافا لمن قال باتهامه في الولد والوالد أو لمن خصّص التّهمة بالولد دون الوالد فإنّه بعيد عن الظنّة في ذلك كلّه لا سيّما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحة أو توقّع مفسدة فتنتفي الظنّة في ذلك رأسا كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد وإن كان فعل معاوية مع وفاق النّاس له حجّة في الباب والّذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنّما هو مراعاة المصلحة في اجتماع النّاس واتّفاق أهوائهم باتّفاق أهل الحلّ والعقد عليه حينئذ من بني أميّة إذ بنو أميّة يومئذ لا يرضون سواهم وهم عصابة قريش وأهل الملّة أجمع وأهل الغلب منهم فآثره بذلك دون غيره ممّن يظنّ أنّه أولى بها وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتّفاق واجتماع الأهواء الّذي شأنه أهمّ عند الشّارع. وهذا كلّه إنّما حمل عليه منازع الملك الّتي هي مقتضى العصبيّة فالملك إذا حصل وفرضنا أنّ الواحد انفرد به وصرفه في مذاهب الحقّ ووجوهه لم يكن في ذلك نكير عليه ولقد انفرد سليمان وأبوه داود صلوات الله عليهما بملك بني إسرائيل لما اقتضته طبيعة الملك من الانفراد به وكانوا ما علمت من النّبوة والحقّ وكذلك عهد معاوية إلى يزيد خوفا من افتراق الكلمة بما كانت بنو أميّة لم يرضوا تسليم الأمر إلى من سواهم.
» فقال: كم سعر متر الألمنيوم «يا أمير المؤمنين أنا في ثغر تجاه العدوّ وبنا إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة» فسكت ولم يخطّئه لما احتجّ عليه بمقصد من مقاصد الحقّ والدّين فلو كان القصد رفض الملك من أصله لم يقنعه الجواب في تلك الكسرويّة وانتحالها بل كان يحرّض على خروجه عنها بالجملة وإنّما أراد عمر بالكسرويّة ما كان عليه أهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والظّلم والبغي وسلوك سبله والغفلة عن الله وأجابه معاوية بأنّ القصد بذلك ليس كسرويّة فارس وباطلهم وإنّما قصده بها وجه اللهفسكت، وهكذا كان شأن الصّحابة في رفض الملك وأحواله ونسيان عوائده حذرا من التباسها بالباطل فلمّا استحضر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم استخلف أبا بكر على الصّلاة إذ هي أهمّ أمور الدّين وارتضاه النّاس للخلافة وهي حمل الكافّة على أحكام الشّريعة ولم يجر للملك ذكر لما أنّه مظنّة للباطل ونحلة يومئذ لأهل الكفر وأعداء الدّين فقام بذلك أبو بكر ما شاء الله متّبعا سنن صاحبه وقاتل أهل الرّدّة حتّى اجتمع العرب على الإسلام ثمّ عهد إلى عمر فاقتفى أثره وقاتل الأمم فغلبهم وأذن للعرب بانتزاع ما بأيديهم من الدّنيا والملك فغلبوهم عليه وانتزعوه منهم ثمّ صارت إلى عثمان بن عفّان ثمّ إلى عليّ رضي الله عنهما والكلّ متبرّءون من الملك منكّبون عن طرقه وأكّد ذلك لديهم ما كانوا عليه من غضاضة الإسلام وبداوة العرب فقد كانوا أبعد الأمم عن أحوال الدّنيا وترفها لا من حيث دينهم الّذي يدعوهم إلى الزّهد في النّعيم ولا من حيث بداوتهم ومواطنهم وما كانوا عليه من خشونة العيش وشظفه الّذي ألفوه، فلم تكن أمّة من الأمم أسغب عيشا من مضر لمّا كانوا بالحجاز في أرض غير ذات زرع ولا ضرع وكانوا ممنوعين من الأرياف وحبوبها لبعدها واختصاصها بمن وليها من ربيعة واليمن فلم يكونوا يتطاولون إلى خصبها ولقد كانوا كثيرا ما يأكلون العقارب والخنافس ويفخرون بأكل العلهز وهو وبر الإبل يمهونه 90 بالحجارة في الدّم ويطبخونه وقريبا من هذا كانت حال قريش في مطاعمهم ومساكنهم حتّى إذا اجتمعت عصبيّة العرب على الدّين بما أكرمهم الله من نبوة محمّد صلّى الله عليه وسلّم زحفوا إلى أمم فارس والرّوم وطلبوا ما كتب الله لهم من الأرض بوعد الصّدق فابتزّوا ملكهم واستباحوا دنياهم فزخرت بحار الرّفه لديهم حتّى كان الفارس الواحد يقسم له في بعض الغزوات ثلاثون ألفا من الذّهب أو نحوها فاستولوا من ذلك على ما لا يأخذه الحصر وهم مع ذلك على خشونة عيشهم فكان عمر يرقّع ثوبه بالجلد وكان عليّ يقول: «يا صفراء ويا بيضاء غرّي غيري» وكان أبو موسى يتجافى عن أكل الدّجاج لأنّه لم يعهدها للعرب لقلّتها يومئذ وكانت المناخل مفقودة عندهم بالجملة وإنّما يأكلون الحنطة بنخالها ومكاسبهم مع هذا أتمّ ما كانت لأحد من أهل العالم قال المسعوديّ في أيّام عثمان اقتنى الصّحابة الضّياع والمال فكان له يوم قتل عند خازنه خمسون ومائة ألف دينار وألف ألف درهم وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما مائتا ألف 91 دينار وخلّف إبلا وخيلا كثيرة وبلغ الثّمن الواحد من متروك الزّبير بعد وفاته خمسين ألف دينار وخلّف ألف فرس وألف أمة وكانت غلّة طلحة من العراق ألف دينار كلّ يوم ومن ناحية السّراة أكثر من ذلك وكان على مربط عبد الرّحمن بن عوف ألف فرس وله ألف بعير وعشرة آلاف من الغنم وبلغ الرّبع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفا وخلّف زيد بن ثابت من الفضّة والذّهب ما كان يكسر بالفئوس غير ما خلّف من الأموال والضّياع بمائة ألف دينار وبنى الزّبير داره بالبصرة وكذلك بنى بمصر والكوفة والإسكندريّة وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة وشيّد داره بالمدينة وبناها بالجصّ والآجر والسّاج وبنى سعد بن أبي وقّاص داره بالعقيق ورفع سمكها وأوسع فضاءها وجعل على أعلاها شرفات وبنى المقداد داره بالمدينة وجعلها مجصّصة الظّاهر والباطن وخلّف يعلى بن منبّه 92 خمسين ألف دينار وعقارا وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف درهم 1 هـ- كلام المسعوديّ.
If you have any concerns about the place and how to use كم سعر متر الالمنيوم للشبابيك, you can call us at the web site.